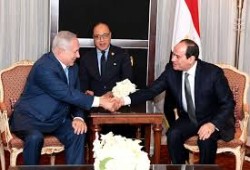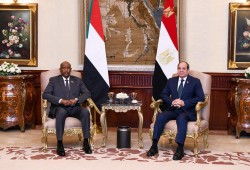كشفت الفيضانات الأخيرة في مصر والسودان—التي ارتبطت بإطلاق كميات كبيرة من مياه بحيرة سدّ النهضة وهي ممتلئة—أن الخطر لم يعد محصورًا في “نقص المياه” فقط، بل صار خليطًا قاتلًا من موجات فيضان مفاجئة ثم شحّ محتمل لاحقًا، وسط إدارة إثيوبية أحادية لا تكترث بعواقبها.
لكن الأخطر من تعسف أديس أبابا هو أن حكومة الانقلاب في القاهرة، رغم امتلاكها مؤسسات وخبرات وبنية تحتية ضخمة (السد العالي والقناطر وشبكات التنظيم)، تعاملت مع إنذار متوقع بعقلية “الإنكار ثم اللوم”، فتركت الفلاحين في مواجهة الماء وحدهم، ثم حوّلت الضحايا إلى متهمين بـ“التعدي” على النهر.
إثيوبيا تُفرّغ.. والقاهرة تتفرّج
إدارة إثيوبيا لتصريفات السدّ—بحسب ما يفهم من السياق—بدت أقرب إلى تصرف عدائي: إطلاق هائل من بحيرة ممتلئة بما يضاعف مخاطر الفيضانات ويخلق حالة عدم يقين للموسم كله.
هنا يبرز طرح د. عباس شراقي الذي طالما شدد في قراءاته العامة لملف السد على أن التشغيل دون اتفاق مُلزم يعني “تقلبات مفاجئة” لا تُدار سياسيًا فقط بل تُدار هيدرولوجيًا على حساب دول المصب، وأن الخطر يتضاعف عند تزامن التفريغ مع موسم أمطار.
ويضيف د. محمد نصر الدين علام (وزير الري المصري الأسبق) في مقاربته المتداولة عادةً أن أي إدارة أزمة لا بد أن تبدأ من “بيانات فورية وشفافة” عن المناسيب والتصرفات، لأن التأخير في التحذير يساوي خسائر مباشرة في المحاصيل والمساكن.
على الجانب السوداني، فإن أثر الصدمة يكون أشدّ بحكم القرب الجغرافي من السد وواقع الانقسام المؤسسي بسبب الحرب الداخلية؛ وهو ما يفسر اتساع الضرر البشري والزراعي في عدة ولايات.
ويُقرأ موقف السودان هنا من زاويتين: هندسية وسياسية؛ فالمهندس ياسر عباس (وزير الري السوداني السابق) كان من أبرز من طالبوا تاريخيًا بآلية تبادل بيانات وتشغيل منسق، لأن السودان—قبل مصر—هو الحلقة التي تتلقى الضربة الأولى عندما تتبدل التصرفات فجأة.
أما د. سلمان محمد أحمد سلمان (خبير القانون الدولي للمياه) فيؤكد في تحليلاته المعروفة أن غياب الاتفاق الملزم لا يخلق “خلافًا تفاوضيًا” فقط، بل يخلق “فراغًا قانونيًا” يسمح بإدارة الأمر الواقع بلا محاسبة، ويحوّل الكلفة إلى فلاحين وسكان لا علاقة لهم بطاولة المفاوضات.
فشل الجاهزية: دولة تملك السد العالي وتخسر أمام “سيناريو متوقع”
النص يطرح سؤالًا مباشرًا: إذا كان الفيضان “مصطنعًا” ومتوقعًا مع بدء التشغيل وموسم الأمطار، فلماذا لم تظهر الجاهزية الوقائية بقدر المخاطر؟
هنا تصبح حكومة الانقلاب في موضع اتهام مهني لا سياسي فقط؛ لأنها تمتلك أدوات إدارة المناسيب—فتح بوابات السد العالي، تفعيل مفيض توشكى، خفض منسوب النهر قبل وصول الذروة—ومع ذلك بدت استجابتها متأخرة ومجزأة بين تحذيرات متناقضة (محافظتان ثم 15 محافظة).
ويحذر د. نادر نور الدين (أستاذ الموارد المائية والري) في قراءاته العامة لأزمات الري من أن المشكلة في مصر لم تعد “قلة الموارد” وحدها، بل “سوء الإدارة وتسييس القرار الفني”، حيث يتحول التخطيط إلى رد فعل، وتتراجع قيمة الرصد المبكر والسيناريوهات لصالح خطاب علاقات عامة لا يحمي محصولًا ولا بيتًا.
هذا ما يعكسه المشهد الذي وصفه النص: أجهزة محلية تحاول الإنقاذ بلا خطة مسبقة، وفلاحون يتحركون بمراكب بدائية لإنقاذ أطفالهم ومحاصيلهم، بينما الحكومة تكتفي بالتحذير ثم تتراجع خطوة إلى الخلف عند لحظة التعويض والحصر.
تجريم الضحايا: حين تتحول الدولة إلى خصم للفلاح
بدلًا من التعامل مع الكارثة باعتبارها أزمة “حماية سبل عيش”، اتجه الخطاب الرسمي—وفق النص—إلى اتهام المتضررين بالتعدي على حرم النهر وتعطيل التصريف، وصولًا إلى التلويح بإعادة حصر “المخالفات” وتجريم الزراعة في أراضي طرح النهر.
هذه ليست إدارة أزمة، بل سياسة عقابية تُدار من أعلى ببرود طبقي: الحكومة تؤجر الأرض بعقود “حق انتفاع” ثم تتظاهر بأنها لم تكن تعلم أن الناس تزرع هناك “منذ عشرات السنين”، وكأنها تجهز لتصفية الريف لا لحمايته.
الصحفي عصام شعبان—من موقعه المهني—يلفت عادةً إلى أن أخطر ما في هذه الأزمات ليس الفيضان نفسه، بل “إعادة تعريف الضحية كمجرم” داخل البيانات الرسمية، لأن ذلك يفتح باب التنصل من التعويضات ويشرعن الإخلاء ويُسكت الشكوى.
وبين سدّ إثيوبي قد يحجب المياه أو يغرق الأرض، وحكومة انقلاب تُفضّل اتهام الفلاح بدل حمايته، يصبح الريف الخاسر الأكبر: تتقلص المساحات، ترتفع الديون، تتسارع الهجرة، ويُدفع المجتمع كله فاتورة “عجز الدولة” في ملف هو أساس الأمن القومي والغذائي