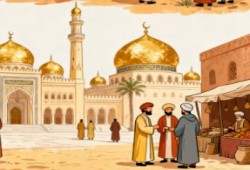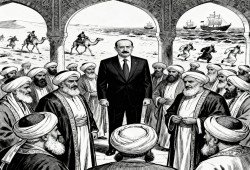يثير موضوع استغفار النبي ﷺ تساؤلاً جوهرياً لدى الكثيرين: إذا كان الأنبياء معصومون من الذنوب، فلماذا أمر الله نبيه بالاستغفار في القرآن الكريم؟ وما الحكمة من كثرة استغفاره ﷺ في حياته اليومية؟
في هذا المقال، نتعمق في تفسير الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع، ونستكشف آراء العلماء لفهم الأبعاد الحقيقية لاستغفار من غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وقفة مع قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾
يأمر الله تعالى نبيه في سورة محمد، الآية 19: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾
وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عدة أوجه لمعنى هذا الأمر:
- استغفار وقائي: أي اطلب من الله أن يحفظك ويقيك من الوقوع في أي ذنب.
- استغفار للعصمة: أي اسأل الله أن يعصمك من الذنوب.
- تثبيت وإرشاد للأمة: قد يكون الخطاب موجهاً للنبي ﷺ ولكن المراد به تعليم الأمة وتوجيهها إلى ضرورة الاستغفار.
- قدوة وتشريع: أمر الله نبيه بالاستغفار ليكون قدوة لأمته من بعده.
- تفسير قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾
وفي آية أخرى قال تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ [الفتح: 2]، فذكر الذنب في حق الرسول ﷺ رغم أنه معصوم، والعلماء حينما بحثوا مثل هذه الآيات قالوا: هي من باب: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
ومعلوم أن المقربين درجة من درجات الطاعة والامتثال لله أعلى من درجة الأبرار؛ لأن الأبرار هم الذين يطيعون الله ويفعلون الخيرات وينفذون الأوامر.
أما المقربون فهم الذين يزيدون على ذلك تقربا إلى الله، حتى في عرف الناس المقرب منك هو الصديق الملازم لك الذي لا يفارقك، ويحبك ويخاف عليك، كذلك المقرب من الله له قانون آخر في التعامل غير قانون الأبرار، ومقياس آخر للحسنات والسيئات يناسب درجة قربه من ربه عز وجل.
ترى لو أنك مثلا مرضت لا قدر الله، وجاءك أحد معارفك وزارك في مرضك ولو مرة واحدة، ماذا تفعل؟ تشكره وترى أنه أدى الواجب.
أما صديقك المقرب، فلو زارك مرة احدة مثله ماذا تفعل؟ تعاتبه وتلومه؛ لأنك كنت تنتظر منه أكثر من زيارة، هذا هو معنى: حسنات الأبرار سيئات المقربين.
إذن الحسنة من الإنسان العادي قد تعد سيئة بالنسبة للنبي ﷺ، فالنبي ﷺ مقرب، وللمقرب حساب آخر، ولهذه القربى ثمن، وكان الله يقول لك: حافظ على هذه الدرجة من القرب مني، وإياك أن يحدث منك ولو شيئا يسيرا بالنسبة لغيرك.
أو أن سيدنا رسول الله ﷺ كما قال: “رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”، فقوله (عن أمتي) يعني: أنه غير داخل في هذا الحكم، فلا يجوز منه النسيان الذي يجوز من غيره، والنسيان في حقه إذا يعد ذنبا.
وقال الآلوسي رحمه الله تعالى:
والأمر في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، قيل على معنى الثبات أيضا، وجعل الاستغفار كناية عما يلزمه من التواضع وهضم النفس، والاعتراف بالتقصير؛ لأنه ﷺ معصوم أو مغفور، لا مصر ذاهل عن الاستغفار، وقيل: التحقيق أنه توطئة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولعل الأولى إبقاؤه على الحقيقة من دون جعله توطئة.
والنبي ﷺ كان يكثر الاستغفار، والذنب بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ترك ما هو الأولى بمنصبه الجليل، ورب شيء حسنة من شخص سيئة من آخر؛ كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقد ذكروا أن لنبينا ﷺ في كل لحظة عروجا إلى مقام أعلى مما كان فيه، فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنبا بالنسبة إلى ما عرج إليه، فيستغفر منه، وحملوا على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: (إنه ليغان على قلبي)؛ الحديث، وفيه أقوال أخر.
وقوله تعالى: (وللمؤمنين) على حذف مضاف بقرينة ما قبل؛ أي: ولذنوب المؤمنين، وأعيد الجار؛ لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام، فإنها معاص كبائر وصغائر، وذنبه ﷺ ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل، ولا يبعد أن يكون بالنسبة إليهم من أجل حسناتهم، قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه، فكأن ذواتهم عين الذنوب، وكذا فيه إشعار بكثرتها، وجوز بعضهم كون الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلب المغفرة لهم، وطلب سببها كأمرهم بالتقوى، وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز، مع أن في صحته كلاما، فالظاهر إبقاء اللفظ على حقيقته.
تفسير قوله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ [الفتح: 2]؛ قال في التفسير الوسيط: ذكر- سبحانه – مظاهر فضله على رسوله ﷺ، فقال: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾، واللام في قوله: ﴿ ليغفر ﴾ متعلقة بقوله: فتحنا وهي للتعليل، والمراد بما تقدم من ذنبه ﷺ ما كان قبل النبوة، وبما تأخر منه ما كان بعدها.
والمراد بالذنب هنا بالنسبة له ﷺ، ما كان خلاف الأولى، فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، أو المراد بالغفران: الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها، فلا يصدر منه ﷺ ذنب؛ لأن غفران الذنوب معناه: سترها وتغطيتها وإزالتها.
قال الشوكاني: وقوله – تعالى-: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾: اللام: متعلقة بفتحنا وهي لام العلة، قال المبرد: هي لام كي ومعناها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا – أي: ظاهرا واضحا مكشوفا – لكي يجتمع لك مع المغفرة تمام النعمة في الفتح، فلما انضم إلى المغفرة شيء حادث واقع، حسن معنى (كي).
وقال بعض العلماء:
وقوله: ﴿ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾: هو كناية عن عدم المؤاخذة، أو المراد بالذنب ما فرط منه ﷺ من خلاف الأولى بالنسبة لمقامه ﷺ، أو المراد بالغفران: الحيلولة بينه وبين الذنوب كلها، فلا يصدر منه ذنب؛ لأن الغفر هو الستر، والستر إما بين العبد والذنب، وهو اللائق بمقام النبوة، أو بين الذنب وعقوبته، وهو اللائق بغيره.
والمعنى: يسرنا لك هذا الفتح لإتمام النعمة عليك، وهدايتك إلى الصراط المستقيم، ولنصرك نصرا عزيزا، ولما امتن الله عليه بهذه النعم، صدرها بما هو أعظم، وهو المغفرة الشاملة ليجمع له بين عزي الدنيا والآخرة، فليست المغفرة مسببة عن الفتح.
الاستغفار شكرًا لا عن ذنب: “أفلا أكون عبدًا شكورًا؟”
على الرغم من أن الله قد بشّره بالمغفرة الكاملة، كان النبي ﷺ أعبد الناس لربه وأكثرهم استغفاراً وقياماً. وهذا يوضح أن استغفاره لم يكن نابعاً من شعور بالمعصية، بل من شعور عميق بالعبودية والشكر لله.
قال ابن كثير: قال الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة يقول: كان النبي ﷺ يصلي حتى ترم قدماه؛ أي: تتورم، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (أفلا أكون عبدا شكورا).
وعن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه – أي: تتشقق – فقالت له عائشة: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا).
هذا الحديث يكشف جوهر المسألة: كان استغفاره ﷺ وعبادته تعبيراً عن شكره لله على نعمه التي لا تُحصى، ومن أعظمها نعمة المغفرة والعصمة.
خاتمة
إن استغفار النبي ﷺ ليس دليلاً على وقوعه في المعصية، بل هو تشريع للأمة، وقدوة في التواضع، ووسيلة للارتقاء في مقامات القرب من الله، وتعبير عن أسمى درجات الشكر والعبودية للخالق عز وجل. إنه يعلمنا أن الاستغفار ليس للمذنبين فقط، بل هو عبادة دائمة تزيد العبد قرباً ورفعة وصفاءً.