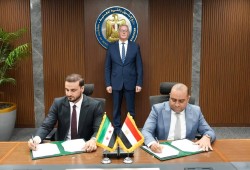تمثل صفقة بيع حصة الأغلبية في سبعة فنادق تاريخية مصرية، من بينها فنادق ذات طابع أثري مسجّل، إلى مجموعة طلعت مصطفى ثم انتقال السيطرة الفعلية إلى شراكة إماراتية، واحدة من أخطر الصفقات التي شهدها قطاع السياحة المصري في السنوات الأخيرة.
فالقضية لا تتعلق بمجرد استثمار فندقي أو شراكة مالية، بل بنموذج اقتصادي كامل يقوم على التفريط في أصول سيادية تدر عملة صعبة دائمة، مقابل سيولة مؤقتة، في ظل غياب فاضح للشفافية، وشبهات تهرب ضريبي، وتجاهل للبعد التاريخي والتراثي لهذه الأصول. هذه الصفقة تكشف كيف تُدار “التنمية” بمنطق البيع السريع، لا بمنطق الحفاظ على الثروة الوطنية.
أولًا - الاستراتيجية الإماراتية.. من الشراكة إلى السيطرة الكاملة
تُظهر تفاصيل الصفقة أن الاستراتيجية الإماراتية لم تكن استثمارًا عابرًا، بل خطة مدروسة للسيطرة الذكية على أصول استراتيجية عالية القيمة. فقد بدأت العملية بدخول صناديق إماراتية مثل ADQ وأدنوك بحصة 40% في يناير 2024، قبل أن تنتهي بشراء الحصة المتبقية في ديسمبر 2025، لتنتقل من وضع “الشريك” إلى “المالك الفعلي”.
خطورة هذه الخطوة لا تكمن في الملكية وحدها، بل في طبيعة الأصول نفسها. فنادق مثل “مينا هاوس” المطل مباشرة على أهرامات الجيزة، و”ونتر بالاس” الأثري في الأقصر، ليست مجرد وحدات فندقية، بل أدوات نفوذ اقتصادي وسياسي ناعم، ترتبط بصورة مصر السياحية وتاريخها العالمي. السيطرة على هذه المواقع تعني امتلاك نقاط ارتكاز في قلب الاقتصاد السياحي المصري.
الأخطر أن هذه السيطرة تمت عبر هياكل قانونية دولية معقّدة، حيث تتركز الملكية النهائية في أبوظبي، بينما تمر عبر كيانات مسجلة في جزر كايمان البريطانية، ما يوفر مظلة حماية قانونية وضريبية، ويصعّب على الدولة المصرية فرض رقابة حقيقية على حركة الأرباح أو المستفيد النهائي منها.
ثانيًا - مجموعة طلعت مصطفى.. الوسيط الرابح دائمًا
في قلب هذه الصفقة تقف مجموعة طلعت مصطفى بدور “الوسيط المالي المحمي”، عبر هيكلة ثلاثية الطبقات تضمن لها الربح وتقليل المخاطر. فالطبقة التشغيلية تعمل داخل مصر عبر شركة “آيكون”، بينما تنتقل الطبقة الوسيطة إلى كيانات مسجلة في كايمان وبريطانيا للحماية الضريبية والقانونية، وصولًا إلى الطبقة المالكة في أبوظبي، حيث تُحوَّل الأرباح النهائية.
هذه الهيكلة لم تكن نظرية، بل انعكست في أرقام صادمة. فقد حققت المجموعة أرباحًا تُقدَّر بـ37 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2023، وهي فترة كانت فيها الفنادق مملوكة للدولة. كما قفزت أرباح القطاع الفندقي من 1.5 مليار جنيه في 2023 إلى 6.7 مليار جنيه في 2024، مع توزيع أرباح عاجلة تجاوزت 35 مليون دولار خلال عام واحد فقط.
هذه الأرقام تطرح سؤالًا جوهريًا: إذا كانت هذه الفنادق قادرة على تحقيق هذا العائد، فلماذا باعت الدولة حصة الأغلبية منها؟ ولماذا لم تُستخدم هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة بدلًا من تحويلها إلى أرباح خاصة تُنقل خارج البلاد؟
ثالثًا - الإخفاق المصري.. سيولة سريعة مقابل خسارة استراتيجية
يمثل الموقف المصري في هذه الصفقة نموذجًا صارخًا للإخفاق الاستراتيجي. فقد ركّزت الدولة على تحصيل 620 مليون دولار فورية، مقابل التخلي عن 51% من أصول تدر إيرادات سنوية قُدّرت بنحو 143 مليون دولار في عام 2024 وحده. أي أن ما بيع ليس عبئًا على الدولة، بل مصدر دخل دولاري مستدام.
الأخطر أن الهيكل الجديد للملكية يسمح بتحويل الأرباح بسهولة إلى الخارج، ما يعني استنزافًا مباشرًا للعملة الصعبة، بدلًا من تعزيز الاحتياطي النقدي. كما تم تجاهل القيمة التراثية للفنادق المسجلة كآثار، دون ضمانات كافية تحمي طابعها التاريخي أو تفرض رقابة صارمة على إدارتها.
وزاد الطين بلة النقص الفاضح في الشفافية، إذ لم تظهر التفاصيل الحقيقية للصفقة إلا في إفصاحات البورصة بعد نحو 15 شهرًا من إتمامها، ما يعني أن الرأي العام حُرم من حقه في النقاش والمساءلة حول صفقة تمس أصولًا سيادية.
ختاما تكشف صفقة بيع الفنادق التاريخية عن خلل عميق في التفكير الاقتصادي الرسمي، يقوم على تفضيل “رأس المال الوارد” على حساب “الثروة المستنزفة”. فالمشكلة ليست في الاستثمار الأجنبي بحد ذاته، بل في نموذج شراكة يسمح ببيع الأصول، والتهرب الضريبي، وتحويل العائد خارج البلاد، دون حماية حقيقية للمصلحة الوطنية. إن استمرار هذا النهج يهدد بتحويل السياحة المصرية من صناعة سيادية مولّدة للدولار، إلى سلعة مالية تُدار من ملاذات ضريبية. والبديل الوحيد هو نموذج استثماري وطني قائم على الشراكة لا التفريط، والشفافية لا الغموض، وحماية حقوق الأجيال لا المقايضة المؤقتة.